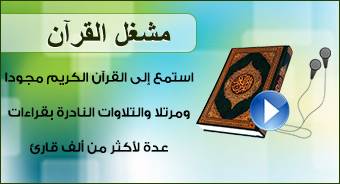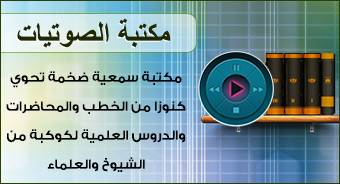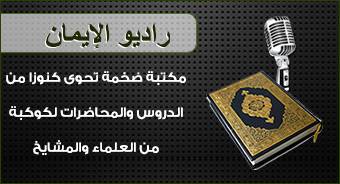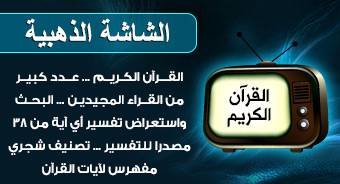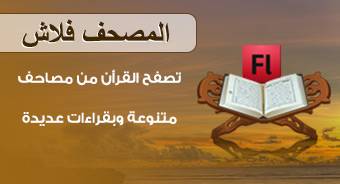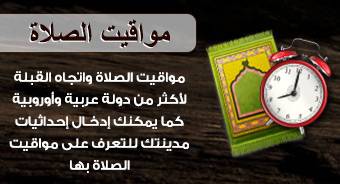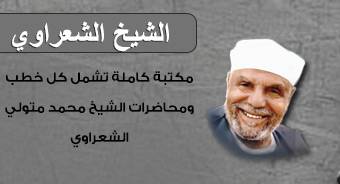|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[معجم متن اللغة 4/ 470، وطلبة الطلبة ص 96].
وقيل: الأفيون: عصارة لينة يستخرج من الخشخاش ويحتوي على ثلاث مواد منومة، منها المورفين. [التهذيب 3/ 9، والموسوعة الفقهية ص 217].
[طلبة الطلبة ص 327].
وفي الاصطلاح: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره ليتراضى الطرفان، ومعناه أيضا: عبارة عن الرفع. وفي الشرع: رفع العقد وإزالته برضى الطرفين، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء لكنهم اختلفوا في اعتبارها فسخا أو عقدا جديدا. وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث. والإقالة في البيع: بفضة وإبطاله. وقال الفارسي: معناه: أنك رددت ما أخذت منه ورد عليك ما أخذ منك. والأفصح: أقاله إقالة، ويقال: (قال) بغير ألف حكاها أبو عبيد في المصنف، وابن القطاع، والفراء، وقطرب قال: وأهل الحجاز يقولون: قلته فهو مقيول، ومقيل وهو أجود. والفسخ والرد وأصله الياء، وقال: المبيع يقيله من حدّ ضرب لغة في إقالة يقيله إقالة. [الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 147، والمصباح المنير مادة (قيل)، والاختيار 2/ 12، والمطلع للبعلي ص 239، وشرح حدود ابن عرفة ص 379، وطلبة الطلبة ص 296، والتوقيف ص 81].
ثبته أو عدّله، وأقام الرجل الشرع: أظهره، وأقام الصلاة: أدام فعلها، وأقام للصلاة: نادى لها. وللإقامة في اللغة معان عدة، منها: الاستقرار، والإظهار، والنداء، وإقامة القاعد. وفي الشرع: تطلق بمعنيين: الأول: الثبوت في المكان، فيكون ضد السفر. الثاني: إعلام الحاضرين المتأهبين للصلاة بالقيام إليها بألفاظ مخصوصة وصفة مخصوصة. المقام: موضع الإقامة بالضم. قال الجوهري: حدر في قراءته، وفي أذانه، يحدر حدرا: إذا أسرع. وحكى أبو عثمان: لا فرق بين القراءة والأذان في الحدر. وقيل: الإقامة: مثل الأذان في الكلمات إلا أنه تزاد فيها كلمتان قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة، والأولى للمؤذن أن يتطوع بين الأذان والإقامة، فإن لم يصل يجلس بينهما، وأما إذا كان في المغرب فالمستحب أن يفصل بينهما بسكتة ويسكت قائما مقدار ما يمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار. هكذا في (الزاهدي). وفي (حواشي كنز الرقائق): يفصل بينهما في الفجر يقرأ عشرين آية، وفي الظهر والعشاء بقدر ما يصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات، وفي العصر بقدر ركعتين يقرأ فيهما عشرين آية. وقيل: هي شروع من الإمام في الصلاة لا إقامة المؤذن. [لسان العرب، والمصباح المنير مادة (قوم)، وتفسير الطبري 15/ 290، وفتح القدير 1/ 178، والكفاية ص 410، والروض المربع ص 59، وطلبة الطلبة ص 170، والمطلع ص 170، والدستور 1/ 146].
[التوقيف ص 81].
قال الجوهري في (الصحاح): اقتبست منه علما: أي استقرأته. وفي الاصطلاح: تضمين المتكلم كلاما شعرا كان أو نثرا، وشيئا من القرآن أو الحديث، وهو له معان عدة أهمها ما ذكر، فإذا كان بهذا المعنى فهو يختلف عن الاستصباح كما ظهر من التعريف. والفرق واضح بين طلب الشعلة وإيقاد الشيء لتتكون لنا شعلة فالإيقاد سابق لطلب الشعلة. أما كون الاقتباس بمعنى تضمين المتكلم كلامه شعرا كان أو نثرا وشيئا من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث، فهو بعيد جدّا عن معنى الاستصباح. [الموسوعة الفقهية 6/ 16، 17].
[طلبة الطلبة ص 284، والتوقيف ص 82].
قدوة: أي يقتدى به ويتأسى بأفعاله. ويستعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي، وهو إذا كان في الصلاة يعرفونه: بأنه اتباع المؤتم الإمام في أفعال الصلاة، أو هو ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط خاصة جاء بها الشرع وبينها الفقهاء في كتاب (الصلاة عند الكلام عن صلاة الجماعة). وقيل: هو التأسي: اقتدى به: إذا فعل مثل فعله تأسيا، والقدوة: الأصل الذي يتشعب منه الفروع. [الموسوعة الفقهية 1/ 196، 6/ 18].
[التوقيف ص 82].
واستهما: أي اقتسما، وقيل: اقترعا. [طلبة الطلبة ص 277].
واقتراف الذنب: فعله، ولذلك يقال: (الاعتراف يزيل الاقتراف). والاقتراف: الجماع. [التوقيف ص 82].
[التوقيف ص 80].
ويستعمل الفقهاء كلمة (الاقتصاد) بمعنى: التوسط بين طرفي الإفراط، والتفريط حيث إن له طرفين هما ضدان له: تقصير ومجاوزة، فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين. قال العز بن عبد السلام: الاقتصاد رتبة بين رتبتين، ومنزلة بين منزلتين. والمنازل ثلاثة: 1- التقصير في جلب المصالح. 2- الإسراف في جلبها. 3- الاقتصاد بينهما. فالتقصير سيئة، والإسراف سيئة، والحسنة ما توسط بين الإسراف والتقصير، وخير الأمور أوسطها. قال ابن القيم: أما الفرق بين الاقتصاد، والشح: إن الاقتصاد: خلق محمود يتولد من خلقين: عدل وحكمة، فالعدل يعتدل في المنع والبذل، وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذي يليق به فيتولد من بينهما الاقتصاد. أما الشح: فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس، ويمده وعد الشيطان حتى يصير هلعا، والهلع: شدة الحرص على الشيء والشره به فيتولد عنه المنع لبذله، والجزع لفقره. [م. م الاقتصادية ص 73].
[الموسوعة الفقهية 6/ 38].
وهو في استعمال الفقهاء بمعناه اللغوي. ويستعمله الأصوليون بمعنى الدلالة، يقولون: الأمر يقتضي الوجوب: أي يدل عليه، ويستعملونه أيضا بمعنى الطلب. أو هو طلب الفعل مع المنع عن الترك، وهو الإيجاب، أو بدونه وهو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل، وهو التحريم، أو بدونه وهو الكراهة. أو هو المطالبة بقضاء الدين، ومنه قولهم: (هذا يقتضي كذا، ومقتضاه كذا). قال الشيخ ابن عرفة رضي الله عنه: (الاقتضاء عرفا قبض ما في ذمة غير القابض)، ويقال: اقتضى الدين، وتقاضاه: أي طلبه. [المصباح المنير (قضي) ص 507، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 344، والموسوعة الفقهية 6/ 41].
[الموسوعة الفقهية 6/ 41].
[نهاية المحتاج 5/ 305، وبدائع الصنائع 7/ 247، والتعريفات ص 270، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 344، والتوقيف ص 82، 83، ودستور العلماء 1/ 147].
[التوقيف ص 83]. |